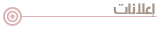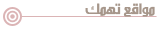نظرية «خصوصيتنا»
24 مارس 2016 - جريدة اليوممحمد العباس
نظريات فيثاغورس ودالتون وأرخميدس وآينشتاين وآدم سميث وغيرهم خضعت على مر العصور وبموجب الاكتشافات المتجددة للدراسة والتحليل والاستدراك والتعديل، وهذا هو شأن أي نظرية في كل الحقول، سواء كانت تربوية أو فيزيائية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو رياضية، إذ لا يمكن للعلوم والآداب أن تتطور وتلبي حاجات اللحظة إلا حين تتزحزح عن مواقفها وتبتعد عما يُسمى بثوابتها، ما عدا نظرية واحدة ظلت راسخة وعنيدة بشكل محيّر وهي نظرية «خصوصيتنا» التي صمدت في وجه كل التغيرات والتبدلات الزمانية والمكانية، واحتفظت بطزاجتها وأركانها العنيدة إلى اليوم.
 ولأنها نظرية أصيلة وغير قابلة لا للتعديل ولا للمساءلة يصعب معرفة من ابتكرها ومن أرسى أصولها المنطقية، فهي نتاج مجتمع بكامله يريد لنفسه البقاء خارج التاريخ، بمعزل عن أي تغيير خلافاً للسُنن الكونية، نعم، فهي نظرية تأسست على قاعدة خوف اجتماعي وفردي من التغيير، وعلى الاستخفاف بكل ما ينتجه الآخر، وعلى إحساس وهمي بالاستهداف من قوى خارجية، وعلى استصفاء روحي أخلاقي لا يدانيه الآخرون وهكذا، بمعنى أن الوعي المجتمعي صار ينسج تلك الأوهام ويضخمها عبر السنين ليمنع أي موجة من موجات التغيير الكونية من الوصول، بدعوى أن ما ينطبق على كل البشر لا يناسبنا كمجتمع.
ولأنها نظرية أصيلة وغير قابلة لا للتعديل ولا للمساءلة يصعب معرفة من ابتكرها ومن أرسى أصولها المنطقية، فهي نتاج مجتمع بكامله يريد لنفسه البقاء خارج التاريخ، بمعزل عن أي تغيير خلافاً للسُنن الكونية، نعم، فهي نظرية تأسست على قاعدة خوف اجتماعي وفردي من التغيير، وعلى الاستخفاف بكل ما ينتجه الآخر، وعلى إحساس وهمي بالاستهداف من قوى خارجية، وعلى استصفاء روحي أخلاقي لا يدانيه الآخرون وهكذا، بمعنى أن الوعي المجتمعي صار ينسج تلك الأوهام ويضخمها عبر السنين ليمنع أي موجة من موجات التغيير الكونية من الوصول، بدعوى أن ما ينطبق على كل البشر لا يناسبنا كمجتمع.
للنظرية أدبياتها التي تدفع بهذا الاتجاه، أي رفض التغيير بأي شكل من الأشكال، حيث تتردد دائماً عبارة «الله لا يغير علينا»، بمعناها المضاد لأي جديد، وبما تتضمنه من استرخاء في الحال الذي نحن عليه، وهذه هي طبيعة المجتمعات السكونية التي تهاب الانفتاح على المجتمعات والثقافات الأخرى، حيث يُنظر إلى أي قيمة وافدة على أساس كونها تهديداً حقيقياً لمنظومة القيم والعادات والتقاليد التي تحكم نظامنا الاجتماعي، وبالتالي فهي قد تدمر رومانسية هذا النسيج الذي يميزنا عن بقية خلق الله، وكأن المجتمعات الأخرى تعيش في غابة، وهو الأمر الذي يعزز فكرة هجاء تلك المجتمعات واتهامها بأبشع التهم الروحية والأخلاقية قبالة الطهرانية التي نزعمها عنواناً لمجتمعنا.
للتغيير كلفة باهظة، وهو يحتاج إلى مشروع بإستراتيجية واضحة المعالم، كما يتطلب وجود مبررات ودوافع وخطط، وهي معركة لا أحد يريد خوضها، وهنا يكمن سر معاندة فكرة التغيير، حيث يتم الإجهاز على الدوافع والمبررات قبل أن تتبرعم، وتُقام المصدات المادية واللا مادية في وجه المهبات القادمة من وراء الحدود، ويُنظر لأي مشروع تغييري على أساس كونه محاولة خارجية للفتك بالمجتمع وهكذا، حيث تأخذ فكرة تحصين المجتمع وجاهتها، ويتم إبقاء الحال على ما هو عليه، وعندها تلبس نظرية «خصوصيتنا» لبوس المنهج المتكامل، المتكئ على فكرة التأصيل قبالة التغريب، وتثبيت القيم مقابل الانحلال الأخلاقي.
ومع كل حدث من الأحداث التي يتداولها الاعلام العالمي، وتكشف عن بعض العناوين المتهافتة في أركان هذه النظرية، ترتفع الأصوات دفاعاً عن وهنها، وكأننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم، إذ لا نسمح لأحد بالتعليق على سلوكياتنا ومفاهيمنا وقيمنا وممارساتنا، فيما ندس أنوفنا في أحوال الآخرين وتفاصيل حياتهم بشكل يومي، وهذا هو أيضاً أحد أركان النظرية، حيث يحق لنا تعقيم الآخرين وانتقادهم والسخرية منهم، ولا يحق لهم أن يتدخلوا في شأن من شؤوننا؛ لأننا نحمي كل عورات النظرية الاجتماعية بإضفاء طابع القدسية على مجريات حياتنا البسيطة، وتسييج أفعالنا البشرية بسياج يصعب الاقتراب منه.
أما ما يكفل متانة النظرية واستمراريتها بهذه القوة والحصانة، فهو قدرتها على تخريج سلالات رافضة للتغيير، وراغبة في تكريس فكرة الخصوصية، وهذا هو الجانب الأخطر منها، فهي لا تتطور لتواكب العصرية، بل لتبتكر أساليب جديدة للانغلاق وتخويف الأجيال من أي تحول بأي اتجاه، بدعوى أن كل ما يُكتشف من العلوم والمناهج والاختراعات يوجد لدينا نسخة منها، أكثر أصالة ونقاءً، وهو ما يعني تدمير بيئة التغيير، وتبديد أي وعد بالخروج من أسوار النظرية، التي أضحت بمثابة السجن الذي يحتضننا جميعاً ويمنع عنا هواء العالم، حيث تتضاءل فُرص فحص النظرية أو تعديلها تحت أي ذريعة.